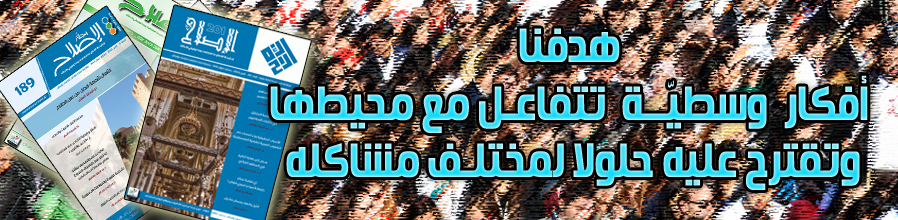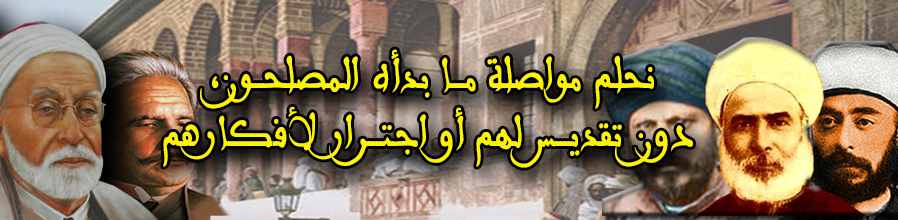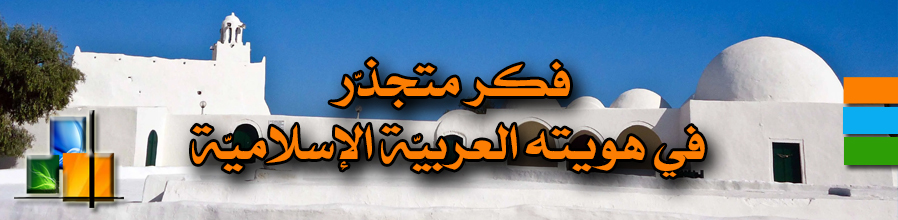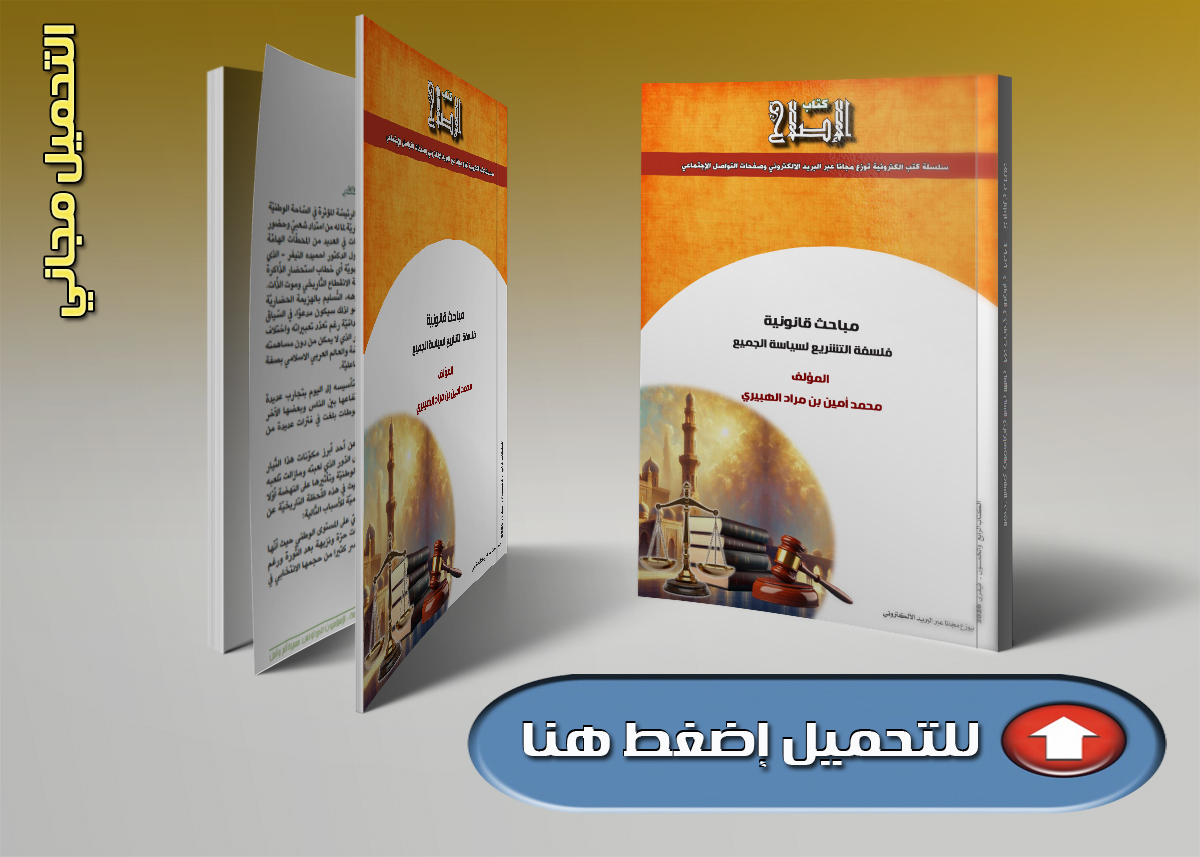-
هل هي مجرّد صدفة أن يفتتح الوحي السّماويّ خطابه الأوّل للرّسول محمّد ﷺ بكلمة آمرة حازمة هي «اقرأ»؟ أم أنّها كانت إشارة تأسيسيّة بأنّ هذا الدّين لن تقوم له قائمة إلّا بالعلم والمعرفة؟ وكيف تمكّنت الحضارة الإسلاميّة من بسط نفوذها وهيمنتها على العالم القديم لقرون؟ ألم يكن ذلك بفضل «دار الحكمة» وثورة التّرجمة والتّدوين الّتي جعلت من صرير الأقلام نِدّا لقعقعة السّيوف؟ ثمّ، متى بدأ الانكفاء والتّقهقر، ودقّت ساعة الأفول الحضاريّ؟ أليس في اللّحظة الّتي استبدلنا فيها شغف المعرفة بظلمات الجهل، وهجرنا فيها العلوم والكتاب، فغادرنا التّاريخ وصرنا على هامشه؟ وهل كان الاستعمار الحديث غافلاً عن هذه المعادلة الدّقيقة؟ أم أنّه عمد بذكاء خبيث إلى تكريس الجهل وتجفيف منابع القراءة، مدركاً يقيناً أنّ الشّعوب الّتي لا تقرأ، تفقد مناعتها، فيسهل قيادها واستعبادها؟
إنّ الإجابة عن هذه التّساؤلات المصيريّة لا تضعنا فقط أمام حقيقة أنّ الكتاب هو خطّ الدّفاع الأوّل، بل تفرض علينا حتميّة وضع استراتيجيّة واضحة المعالم، تنتشل الكتاب من هامش التّرف الثّقافي، لتضعه في قلب الأمن القوميّ، وتجعل منه الرّكيزة الأساسيّة لاستعادة المناعة الحضاريّة وضمان السّيادة الوطنيّة. وحين نتحدث عن الكتاب في هذه الاستراتيجية، فإننا لا نحبس أنفسنا في قفص الورق والغلاف فحسب، بل نقصد الكتاب بمفهومه الحضاري الشامل: ذلك الوعاء الحامل للمعرفة، والناقل للوعي، سواء تجسّد في مخطوط ورقيّ، أو كتاب إلكترونيّ حديث، أو محتوى مسموع؛ فالعبرة ليست في الوعاء، بل في المحتوى الذي يبني العقول ويحمي الذخيرة.
سنحاول من خلال هذا المقال تفكيك العلاقة العضويّة بين الكتاب والأمن القوميّ، انطلاقاً من جدليّة «الجوع والاستعباد»، ومروراً بخطورة «صناعة الوعي من الخارج» وما يولّده من قابليّة للاستعمار، لنخلص في النّهاية إلى طرح مسوّدة استراتيجيّة وطنيّة تتجاوز التّشتّت المؤسّسيّ، وتؤسّس لشراكة فاعلة بين الدّولة والمجتمع غايتها بناء أمّة تفكّر، فتعمل، فتنتج.
م.فيصل العش
-
ورد في الفصل الثّالث من «فَنّ الحرب» للحكيم الصّينيّ المعروف سون تزو Sun Tzu: «الانتصار في مئة معركة ليس من أسمى مهارات المجد، إنّما أسمى مهارة أن تقهر عدوّك بلا قتال». يتغلّب وعي السّياسيّ الواقعيّ حين يُدرك أنّ أعلى مراتب النّصر هو الانتصار بلا حرب، وأنّه يجب ألّا يُهدر الفرص، ويغرق في الأوهام، لأنّ توهّم القوّة لا يصنع القوّة، وتوهّم الانتصار لا يصنع الانتصار. السّياسة في أصلها فَنّ للعيش المشترك، ومجال عامّ تتجسّد فيه مسؤوليّة الإنسان عن تنظيم حياته مع الآخرين. عند أرسطو كانت السّياسة أرقى صُوَر الأخلاق، لأنّها تُعنى بسعادة الجماعة لا بمصلحة الفرد وحده. وفي الفكر الحديث صارت السّياسة فَنّ إدارة الصّراع بالعقل لا بالعنف، وإدارة المصالح بواقعيّة.
أ.د.عبدالجبار الرفاعي
-
يُعدّ كتاب الدّكتور مصدّق جليدي «البنائيّة الاستخلافيّة: بديل تربوي حضاري» دراسة رائدة في الفكر التّربوي البنائي الحضاري، حيث يسعى المؤلّف إلى تقديم رؤية تربويّة جديدة ترتكز على مفهوم البنائيّة الاستخلافيّة كأساس لبناء شخصيّة متوازنة ومجتمع متطوّر مساهم بفاعليّة في الحضارة الإنسانيّة، من خلال التّأليف بين مقومات الأصالة وثوابتها ومقتضيات الحداثة ومتطلباتها من خلال مفهوم الأصالة الحديثة. وقد سعينا من خلال هذا المقال إلى تقديم قراءة تحليليّة للكتاب، مبرزين في الجزء الأول منه (العدد السابق) الإشكاليّة التي ركّز عليها الكاتب في بحثه، ثمّ عرضنا أسس الفكر التربوي الأصيل ومقوّماته ومن ثمّة تطرّقنا إلى خصائصه ومميّزاته. ونخصّص هذا الجزء الثاني والأخير لاستعراض جوانب الالتقاء والتماثل بين الفكر التربوي الأصيل والفكر الإنساني الحديث من جهة و جوانب التّمايز بينهما من جهة أخرى، ونختم المقال بعرض النّظريّة البنائيّة الاستخلافيّة كبديل تربوي حضاري جديد كما يقترحها المفكّر التّربوي الأستاذ مصدّق الجليدي
خليفة بن مسعود
-
يسود الاعتقاد في أنظمة التّعليم والتّكوين البارزة؛ أنّ المؤسّسات والأنظمة التّربويّة هي الفضاء الأكثر تواجدا وقدرة على تعليم النّاس وتنمية عقولهم بالمعرفة والعلوم؛ أو بالإنسانيّات والفنون، ومن يبتغي الانكباب على التّعليم فما عليه إلّا أن يتّجه إلى هذه المؤسّسات: مسجّلا وملتحقا وجالسا بين أفراد متعلّمين، ومعلّم يتولّى هذه المهمّة، ومخبرا أو حقلا لإجراء التّجارب.
وإذ تقرّر هذا، فإنّ الملمح الجوهريّ لهذا النّظام؛ هو ذلك التّرابط العضويّ بين التّعليم والمؤسّسات؛ ورسوخ هذا التّرابط بخاصّة في دائرة المعارف التّكنولوجيّة، الّتي بسبب زحام برامجها وطول وقتها؛ لم يجد المنتسبون إليها الفراغ الّذي يروي عطشهم المعرفيّ نحو علوم الإنسان، فبقيت أحوالهم العقليّة والنّفسيّة ممزّقة بين تكوين علميّ خالص، ورغبة روحيّة في المعرفة الإنسانيّة؛ الّتي يسمّيها «فيلهلم دلتاي» : بعلوم الرّوح، الّتي غرضها الفهم، بينما التّفسير هو قصد العلوم الطّبيعيّة.
أ.د. عبدالرزاق بلقروز
-
مساهمةً منّا في تقديم الدّراسات والبدائل ضمن أنشطة «منتدى الفارابي للدّراسات والبدائل»؛ توشك سلسلة مقالاتنا المعنونة بـ «نحو بلورة ملامح نظامٍ ماليّ قويّ ومنصف» - التي شرعنا في نشرها عبر مجلّة «الإصلاح» الإلكترونيّة منذ مطلع العام - على الاكتمال. وقبل الخوض في «مؤسّسات التّأمين» بوصفها ثاني ركائز النّظام الماليّ المنشود؛ يجدر بنا التّذكير - تمهيدًا لهذا المقال - بأبرز ما خلصنا إليه خلال بحثنا في «مؤسّسات التّمويل الأصغر» (أولى ركائز ذلك النّظام). فقد رصدنا ثلاثة إشكالاتٍ رئيسة تواجه التّمويل الإسلاميّ أثناء معالجته لظاهرتي الفقر والبطالة؛ وهي إشكالاتٌ شملت: منتجات التّمويل، ومؤسّساته، ومصادره، كما نبّه إليها الباحث أنس الحسناوي. وقد أعاقت تلك العقبات عمليّة تمويل الفقراء في الواقع، رغم الفرص الكبيرة التي يُتيحها الطّرح النّظريّ للتمويل الإسلاميّ.
وفي سياق البحث عن حلول، توصّلنا إلى أنّ الالتزام بمقاصد الأحكام الشّرعيّة، وحُسن تفعيل مؤسّسات التّمكين الاقتصاديّ الإسلاميّ، وابتكار صيغٍ جديدةٍ للوقف؛ يُمكنها مجتمعةً معالجة إشكاليّة غياب التّمويل الفعليّ للفقراء. وعمليًّا، برزت مؤسّسات التّمكين الاقتصاديّ، ومفاهيم التّمويل التّنمويّ، والوقف التّنمويّ؛ وهو ما فصّلناه في مقالٍ سابقٍ على أعمدة المجلّة.
أمّا اليوم، ولمواجهة الإشكال الثّالث المتعلّق بـ «المنتجات»، تبرز تجربة التّأمين التّكافليّ في ماليزيا أنموذجًا نوعيًّا. ولكن، قبل استعراض تلك التّجربة للاستفادة منها، سنقف أوّلًا عند واقع قطاع التّأمين عالميًّا ومحليًّا في تونس.
نجم الدّين غربال
-
سيتركزّ المسار العامّ لقضيَّة فلسطين سنة 2026 على محاولة الإسرائيليِّين والأميركان وحلفائهم، معالجة آثار ما بعد طوفان الأقصى، ومحاولة ترميم صورة إسرائيل وإعادة تأهيلها في البيئة العربيَّة والدّوليَّة، وإيجاد ظروف أنسب للتّطبيع و «الاتِّفاقات الإبراهيميَّة».
كما سيتمّ التَّركيز على إخراج حماس من المعادلة السّياسيَّة الفلسطينيَّة، ونزع قدراتها العسكريَّة. وستحاول سلطة رام الله ملء الفراغ السّياسيّ والإداريّ في قطاع غزَّة، بالرّغم من أنَّها ستعاني من تراجع واستنزاف في الضِّفَّة الغربيَّة، مع سعي الاحتلال الإسرائيليّ لإحداث فراغ في الضِّفَّة، في إطار إجراءات الضّمّ والتَّهويد المتصاعدة هناك، وستبقى القدس العنوان الأبرز لمعركة الهويَّة والتَّهويد.
أ. د. محسن محمد صالح
-
إنّ تطرّقنا بالدّراسة لحادثة الإفك يدخل في باب إعادة فهم ما يُشكّل الوعي الحالي، إنْ بصورة كلّية أو جزئيّة. ومن هذا المنطلق يتأكّد الحفر في صفحات عديدة من الموروث لإعادة بنائه عبر الفهم والنّقد والمقارنة والتّدقيق انطلاقا من عرض الرّواية على الرّواية، وإظهار ما تعمّدت الأعراف الثّقافيّة إخفاءه رغم ورود ما يدلّ عليه في المدوّنات والموسوعات. وليس أمام البحث العلمي إلاّ النّبش في الوثائق وتدبّر النّصوص من أجل إنتاج معارف جديدة وأفهام مغايرة لما صوّر على أنّه نهائي. وإذا أثبتت التّواريخ بطلان رواية أو زيف حكاية، فإنّ واجب الباحث لا يزيد عن التّنبيه والتّوضيح.
تطرقنا في الحلقين الأوليين من هذه السلسلة إلى قصّة حادثة الإفك في التراث، ثمّ خصّصنا ثلاث حلقات متتالية للحديث عن المستشرقين وما توّصلوا إليه من نتائج من وحي هذه القصّة.ثمّ خصصنا الحلقة السادسة للنبش في سند الرواية التراثية ومتنها، لتتهاوى أمام الحجّة والبرهان، ثمّ قمنا في الحلقة السابعة بتقديم عرض نراه كاشفا لحقيقة ما تضمّنته سورة النّور من حقائق وأفكار .وخلصنا إلى ضرورة مزيد التّمحيص في المرويّات نظرا لتأثرها بالسّياق الاجتماعي والسّياسي والمذهبي في زمانها، وبناء على ذلك تحدثنا في الحلقة الثامنة عن حادثة التّحكيم بوصفها منعرجا خطيرا في حياة المسلمين، كان له كبير الأثر في توجيه الثّقافة توجيها مخصوصا حيث تترسّخ غلبة السّياسي على الدّيني. وبيّنا في الحلقتين السابقتين كيف تؤدّي هذه الغلبة إلى فهم المُصحف فهما معيّنا وتوجيه معانيه توجيها قيصريّا يتماهى مع الموقف السّياسي السّائد القائم على القهر. وكلّما امتزج السّياسي بالدّيني لحقهما الضّيم. فيقدّس غير المقدّس. ويصبح الوعي الدّيني حاملا لمعاني الضّعف والعجز. ونختم في هذه الحلقة بتقديم نتائج البحث الذي عرضناه عليكم في هذه السلسلة من المقالات.
د.ناجي حجلاوي
-
شهدت مقولة التّسامح جملة من التّطوّرات، منذ تداول المفهوم في الأوساط الدّينيّة والسّياسيّة والمعرفيّة في أوروبا، مع مستهلّ الحقبة الحديثة. وبدا ترسيخ المفهوم حينها، في أوضاع مشحونة بالنّزاعات والانقسامات، سبيلًا للخروج من دوّامة الفوضى الّتي ألمّت بالقارّة مع بروز الانشقاقات البنيويّة الكبرى في التّفكير والتّصوّرات، جرّاء الموقف من الحداثة والعلمنة، وجرّاء ما طرأ على مفهوم الدّولة من تبدّل، وما صاحبه من هجران لمفهوم الرّعيّة وانفتاح على مفهوم المواطنة.
د.عزالدين عناية
-
لا تُعدّ اللّغة العربيّة مجرّد وسيلة للتّواصل فحسب، بل هي وعاءٌ للهُوِيّة وضمانةٌ لمستقبل الأمّة؛ لذا وجب إحياؤها وحمايتها عبر سياسات واستراتيجيّات فعّالة. ضمن هذا السياق، تأتي هذه الدراسة الموزّعة على جزأين: استعرضنا في الأول (العدد 222) اللّغة العربيّة من منظور حضاريّ وتاريخيّ ومعرفيّ، مناقشين مكانتها بين لغات العالم ودورها في بناء الهُوِيّة والثّقافة والعلوم، ثمّ تناولنا التّحدّيات الّتي تواجهها في العصر الحديث، مثل الإهمال التّعليميّ والقصور التّكنولوجيّ وتأثيرات العولمة. وسنخصّص هذا الجزء لاقتراح إستراتيجيّات عمليّة للحفاظ على لغتنا وتفعيل استخدامها في مختلف المجالات العلميّة والإداريّة والإعلاميّة.
أ.د عبد الفتاح داودي
-
تُعَدّ الأخلاق من أقوى السُّنَن الكونيّة التي تحفَظ للإنسان إنسانيّته، فهي جوهر الوجود الإنسانيّ وروحه. فإذا انعدمت الأخلاق، انعدم الإنسان معنًى، ولم يَبْقَ منه إلّا جسدٌ يَتَحَرَّك بلا روح، يأكل ويشرب ويَتَمَتَّع كما تفعل الأنعام، دون وعي أو بصيرة، فيصبح الإنسان «مبتور الحسّ مُشَوه البصيرة، وفكرته عن الحياة تَهْوِي بقيمة البشر إلى حضيض بعيد»، بمعنى عندما يَتَخَلَّى الفرد أو المجتمع عن الأخلاق، يغرق في التّيه، وتَعُمّ الفوضى الفكريّة، وتسيطر الأهواء، فَيَتَّجِه الإنسان نحو الأنانِيّة وحبّ الذّات، ويغيب عنه الشّعور بالآخر. حينها، لا يعرف المجتمع طعم الرّاحة النّفسيّة ولا السّكينة الرّوحيّة، بل يَتَحَوَّل إلى ساحة صراع، يَتَسَلَّط فيها الإنسان على أخيه الإنسان، وتضيع معها معاني العلاقات الإنسانيّة الرّاقية التي تقوم على الاحترام، والرّحمة، والتّعايش.
د.عبدالله البوعلاوي
-
انتبهت طائفةٌ من المفكّرين بعد غفلةٍ من الزّمن إلى ما آل إليه أمر الأمّة العربيّة والإسلاميّة من حالة الانحطاط التي شملت أغلب وجوه الحياة. فتداعت أصواتهم معلنةً ضرورة قيام مشروعٍ تحديثيٍّ حقيقيّ. ومن أبرز تلك المشاريع مشروع إسلاميّة المعرفة. وهو مشروعٌ ضخمٌ وهامٌّ تشرف عليه مؤسّسةٌ بحثيّةٌ تسمّى المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وقد تأسّس المعهد في 1981، وما زال ينشط في إنتاج المعرفة عبر نشر مئات الكتب والمجلاّت وعقد النّدوات العلميّة. وتتمثّل رسالته في الإسهام في بلورة أفقٍ لإعادة إدراج المسلمين في التّاريخ. ومنهج المعهد هو أسلمة المعرفة، ومن هنا أخذ المشروع تسميته.
إنّ إسلامية المعرفة، كما نبّه على ذلك أصحاب المشروع، مقدّمةٌ منهجيّةٌ معرفيّةٌ لبديلٍ حضاريٍّ عالميٍّ لا يستهدف إنقاذ المسلمين وحدهم، ولكن يستهدف إنقاذ العالم كلّه. فلقد فسدت غايات العلم ومقاصده، وصارت تفترض الإلحاد والنّظريّة الماديّة للكون والوجود والحياة، وانحرفت كثيرٌ من استخداماته وصارت ضارّةً للإنسان.
لقد آمن المنظّرون للمشروع بأنّ التّفكير في طرح بديلٍ معرفيٍّ لحلّ أزمات الأمّة ضروريٌّ كي تستعيد أمجادها، وهو ما جعل إسلاميّة المعرفة أحد المشاريع الفكريّة التي لامست المشكلة التي تعاني منها الأمّة الإسلاميّة في جوهرها، وهي عجز العقل الإسلاميّ المعاصر عن إنتاج مناهج معاصرة تمكّنه من ربط الحاضر بالماضي وصياغة معرفةٍ تستجيب لمتطلّبات العصر. وهو ما يجعل القضيّة المطروحة في مشروع إسلاميّة المعرفة متّصلةً اتّصالًا وثيقًا بجهود التّجديد والنّهوض الحضاري للأمّة العربيّة الإسلاميّة.
وانطلاقًا من هذا الوعي بضرورة التّأسيس المعرفيّ الجديد، يسعى هذا المقال إلى تتبّع مسار المشروع عبر محورين: نخصّص أوّلهما لرصد الدّوافع التي أملت قيامه (موضوع هذا العدد)، ونُفرد ثانيهما لتبيان الأهداف التي يطمح إلى تحقيقها (في العدد القادم).
عبد الحكيم علوي
-
تبحث هذه الدراسة، التي بدأنا ننشرها منذ العدد 220 على أربع حلقات ،رسم خارطة انتشار الإسلاميين في تونس وتفكيك مقالاتهم والبحث في المسكوت عنه في مواقفهم وأفعالهم وأقوالهم في فترة العشر سنوات التي تلت أحداث ثورة 2010-2011. انطلقنا - في الحلقة الأولى- بعد قراءة موجزة في المفاهيم والمصطلحات في استعراض الخطاب الإسلامي في المؤسّسات الرّسمية التّونسيّة وتحليله. ثمّ ردفناها بحلقتين متتاليتين لتّحليل خطاب التّيارات الفكريّة والجماعات الدّينية والأحزاب السّياسيّة الإسلاميّة، فخصّصنا الأولى لتحليل خطاب الحركة الإسلاميّة الإحيائيّة (النهضة)، والتّيار الإسلامي السّلفي، وحزب التّحرير ، والثانية لتحليل الخطاب الإسلامي الحداثي وخطاب اليسار التّونسي في المسألة الإسلاميّة. وفي هذه الحلقة سنعرض مبحثا خاصا بالخطاب الإسلامي في مراكز البحث والدراسات (مركز الإسلام والديمقراطية، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث)، مع خاتمة تلخّص النتائج.
د. محمد شكري المرزوقي
-
إعمال الميزان ـ جنبا إلى جنب مع الكتاب الذي لا ريب فيه ـ فريضة إسلاميّة محكمة وضرورة واقعيّة ملحّة وحاجة عقليّة لا مناص منها في كلّ حقل لأجل بلوغ أقصى ما يمكن من الرّشد والنّضج والعدل والقسط. ليس ذلك خاصّا بزمن ما أو مكان ما ولا حتّى بحقل ما دون غيره.
ترسيخ القسط الذي هو المقصد الأسنى من خلق الإنسان وإستخلافه إستئمانا وتكريما وعمارة للأرض مشروط بتكافل ثلاثية قيمية :
* حسن فقه التّكليف الإلهيّ من ذينك المصدرين الأوّلين المقدسين الحاكمين على كلّ شيء؛
* حسن إستنباط العلّة المناسبة في كلّ تكليف لفقه المقصد والغاية؛
*حسن فقه الواقع الذي عليه يتنزّل ذلك التّكليف من حيث إمكان إحتضانه له أو عدم إحتضانه له.
تلك هي الثّلاثيّة التكافليّة التي لا يكون قسط وعدل وعمارة في الأرض بدونها. ولو تخلّف منها عضو واحد فسد كلّ شيء لفرط تكاملها وشدّة تكافلها. مثلها مثل الطّبيب الذي يفحص المريض أوّلا، ثمّ يحدّد المرض وسببه ثانيا، ثمّ يقدّم العلاج الأنسب لذلك المريض ذاته. ليس الطّبيب يفحص مريضا واحدا ثمّ يصف الدّواء لكلّ من يليه وهو مثله سنّا ونتائج في تحليل السّوائل وعائلة دم وثمرات تحليل. كذلك الفقيه : لا يصف دواء حتّى يقطع تلك الخطوات الثّلاث بنجاح.
الهادي بريك
-
يخضع التّاريخ البشريّ لسنن إلهيّة ثابتة، وفي مقدّمتها «سُنّة التّمكين» الّتي وعد الله بها عباده المؤمنين في قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ...﴾ (النور: 55). ويُعَرّف التّمكين بأنّه قانون إلهيّ يورث السّيادة والاستقرار لمن حقّق شرطي الإيمان والعمل الصّالح. وهو مفهوم شامل يتجاوز الهيمنة الماديّة ليشمل إقامة العدل وتوحيد الله. وتتعدّد مجالاته لتشمل:
* التّمكين الدّينيّ: بسيادة الشّريعة مرجعًا وأخلاقًا في حياة المجتمع.
* التّمكين السّياسيّ: بقيادة الأمّة وفق حكم راشد يجمع بين العدل والكفاءة.
* التّمكين الاقتصاديّ: بتحقيق الاكتفاء الذّاتيّ والاستقلال الماليّ المؤثّر عالميًّا.
* التّمكين الثّقافيّ: بترسيخ الهويّة والقيم المستنيرة حمايةً للأمّة من الذّوبان.
محمد أمين هبيري
-
لم يكن حضور العقل في القرآن الكريم مسألة طارئة في تاريخ التفكير الإسلاميّ، بل ظلّ موضوعًا لإعادة النّظر كلّما أثير السّؤال عن طبيعة العلاقة بين الوحي والنّظر العقليّ؛ ذلك أنّ النصّ القرآنيّ -وهو يخاطب الإنسان في أبعاده المتعدّدة- لا يقتصر على توجيه السّلوك أو ضبط الفعل، وإنّما يستدعي في مواضع كثيرة فعل النّظر، ويضع القارئ أمام أسئلة تتّصل باللّه والكون والإنسان والمصير. وقد انخرط عدد من مفكّري الإسلام قديمًا وحديثًا في مساءلة هذا الحضور، كلّ من زاوية تخصّصه، ساعين إلى تحديد حدوده ووظيفته ومآلاته. وفي هذا السّياق يندرج كتاب «القرآن والفلسفة» لمحمّد يوسف موسى، الذي حاول فيه مقاربة العلاقة بين الخطاب القرآنيّ والتّفكير الفلسفيّ، انطلاقًا من قراءة طبيعة هذا الخطاب، وطريقة معالجته لقضايا شغلت الفلاسفة في تجارب فكريّة متعدّدة.
د. حميد حقي
-
يُعَدّ الإدمان آفةً اجتماعيّةً ذات أبعادٍ نفسيّةٍ وأخلاقيّةٍ، وله تداعيات شديدة الخطر على المؤسّسة العائليّة والبناء الاجتماعيّ. وهذه الآفة الّتي حاقت بعدد كبير من الشّباب تعود إلى أسباب عديدة ومتنوّعة، وهي ظاهرة تدعو إلى الرّصد والتّفهّم من أجل رسم الاستراتيجيّات الوقائيّة والعلاجيّة. ويظلّ علم الاجتماع مسلكًا معرفيًّا كفيلاً بدراسة مثل هذه الظّواهر؛ تشخيصًا وتفعيلاً لآليّات الوقاية والعلاج.
تكمن أهمّيّة هذا الموضوع في تسليط الضّوء على ظاهرة المخدّرات في الوسط المدرسيّ عمومًا؛ ما يُسهم في فهم التّحدّيات الاجتماعيّة والنّفسيّة والصّحّيّة الّتي تواجهها المجتمعات، بما في ذلك الوسط الجامعيّ. وسنعمد إلى تشخيص هذه الظّاهرة وكيفيّة انتشارها، مع محاولة وضع خطط استراتيجيّة لمكافحتها.
وتقوم فرضيّة هذه الورقة البحثيّة على تقديم نموذج نظريّ يفسّر ظاهرة الإدمان على المخدّرات في ضوء النّظريّة «اللّامعياريّة» لعالميْ الاجتماع «إميل دوركايم» و«روبرت ميرتون» في سياق علم اجتماع الانحراف والجريمة. واعتمدنا في إنجازها على المنهجين: التّحليليّ والوصفيّ.
وقد قسّمنا هذا البحث إلى جزأين: الأوّل في هذا العدد، نبدؤه بتعريف الإدمان وأنواعه وآثاره من خلال التّشخيص الاجتماعيّ لهذه الظّاهرة عند الطّلّاب؛ ونخصّص الجزء الثّاني بحول اللّه (في العدد القادم) للحديث عن التّشخيص النّفسيّ للإدمان، وكيفيّة تفعيل آليّات العلاج منه، ووضع استراتيجيّات مكافحته.
د.أشواق طالبي المصفار
-
عدو خفي لكنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية العصرية السريعة. إنه يترصد الحصن المناعي فيضعفه فيصبح الإنسان أكثر عرضة للأمراض، أو يفاقم عللاً صحية موجودة بالفعل؟. فما هي تفاصيل هوية ذلك «العدو الخفي»، وكيف يؤثر على الجهاز المناعي، وكيف يتم تعزيز ذلك الحصن الدفاعي؟.
أ.د. ناصر أحمد سنه
-
تايوان هي مجموعة جزر تقع في جنوب شرق آسيا وتوجد بالجزء الشّرقيّ من بحر الصّين، وهي مطلّة من الشّرق على المحيط الهادئ، ويفصلها مضيق تايوان غربًا عن مقاطعة فوجيان الصّينيّة حيث تبعد عنها مسافة 140 كيلومترًا. وتُمثّل تايوان ديمقراطيّة فتيّة وقوّة تكنولوجيّة كبرى، لكنّها تواجه خطر التّحوّل إلى ساحة صراع بسبب نزاع تاريخيّ مع الصّين الّتي تعدّها إقليمًا منشقًّا وتلوّح بالقوّة، بينما يؤكّد التّايوانيّون استقلالهم.
يرتبط مصير هذه الجزيرة الصّغيرة في جنوب المحيط الهادئ بتوازنات استراتيجيّة واقتصاديّة عالميّة كبرى. فما دوافع الصّين للسّيطرة على تايوان؟ ولماذا تحرص الولايات المتّحدة على دعمها؟ وكيف تشكّل تاريخ تايوان وواقعها الحاليّ؟
حسن الطرابلسي
-
يعيش الإنسان العربيّ اليوم حالة من «إيجاب السّلب»؛ حالة من التّعايش المريض مع الرّداءة والتّكيّف مع العدم. نحن أمام واقع لم يتغيّر، بل ازداد رسوخاً في سباته، حيث تحوّلنا إلى كائنات مجترّة للزّمن، مستهلكة للواقع، لا تشارك في صناعة التّاريخ بل تكتفي بمشاهدته من وراء شاشات هواتفها. إنّها «سيزيفيّة» عربيّة بامتياز، حيث ندحرج صخرة الفشل يوميّاً لنعود في المساء إلى نقطة الصّفر، في دوّامة من كثرة الكلام وقلّة الفعل. إنّها بيئة «آسنة» بطبعها، والبيئة الآسنة لا تنتج إلّا الرّكود، فهي تربة مسمومة تقتل بذور الإبداع في مهدها، وتخنق كلّ محاولة للخروج عن السّائد.
شكري سلطاني
-
يُعَدُّ السلطان «محمود غازان» علامةً فارقةً في تاريخ الدولة الإيلخانية ببلاد فارس، وأحد أقوى سلاطينها شكيمةً وأكثرهم تأثيراً. ولا تكمن أهميته في قوته العسكرية فحسب، بل في كونه أول الملوك المغول الذين اعتنقوا الإسلام رسمياً، مدافعاً عنه ومؤسساً لمرحلة جديدة أعقبت حقبة الاجتياح المغولي الدامي لآسيا الوسطى وفارس والعراق والشام.
عبدالقادر رالة
-
في ظلّ التّحدّيات الحضاريّة المعقّدة الّتي تواجه العالم الإسلاميّ، تبرز أصواتٌ فكريّة لا تكتفي بتشخيص الدّاء، بل تسعى لتقديم وصفاتٍ عمليّة للدّواء. ويُعدّ الدّكتور عبد الكريم بكّار واحدًا من أبرز هذه الأصوات الّتي كرّست جهدها لـ «هندسة العقل المسلم» وإعادة بنائه ليكون قادرًا على التّعاطي مع استحقاقات العصر.
التحرير الإصلاح
-
العمْـــــر ينتهبُ الدروبـــــــــا
ما قد تصــرَّم لن يــــــؤوبـــــــا
والشَّــمْـسُ، شمْسـُك يــا طويـــل
العمْـــــرِ، توشـــك أن تغيبـــــا
د.حسن الأمراني
-
بِضاعةٌ مَمنُوعةٌ رائِجةٌ،
تُباعُ تُشتَرى، بفيضِ مَدَدٍ
مِن الرَّخاءِ والهَناءْ.
يُرسِلُها أَصْحابُها،
في السِّرِّ والإِعلانِ،
لا يَمسُّها شَرٌّ وَلا عَداءْ.
رشيد سوسان