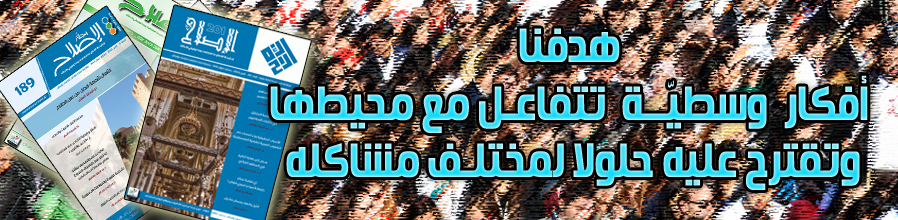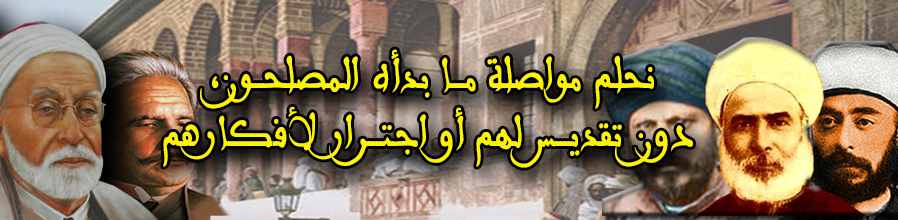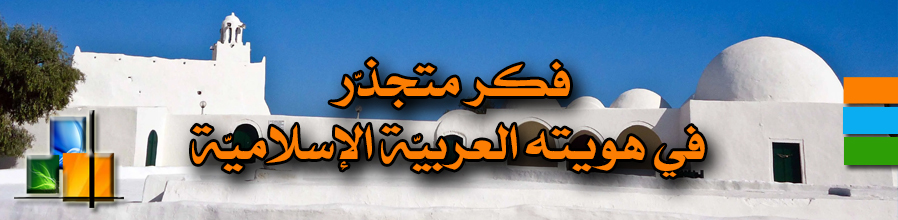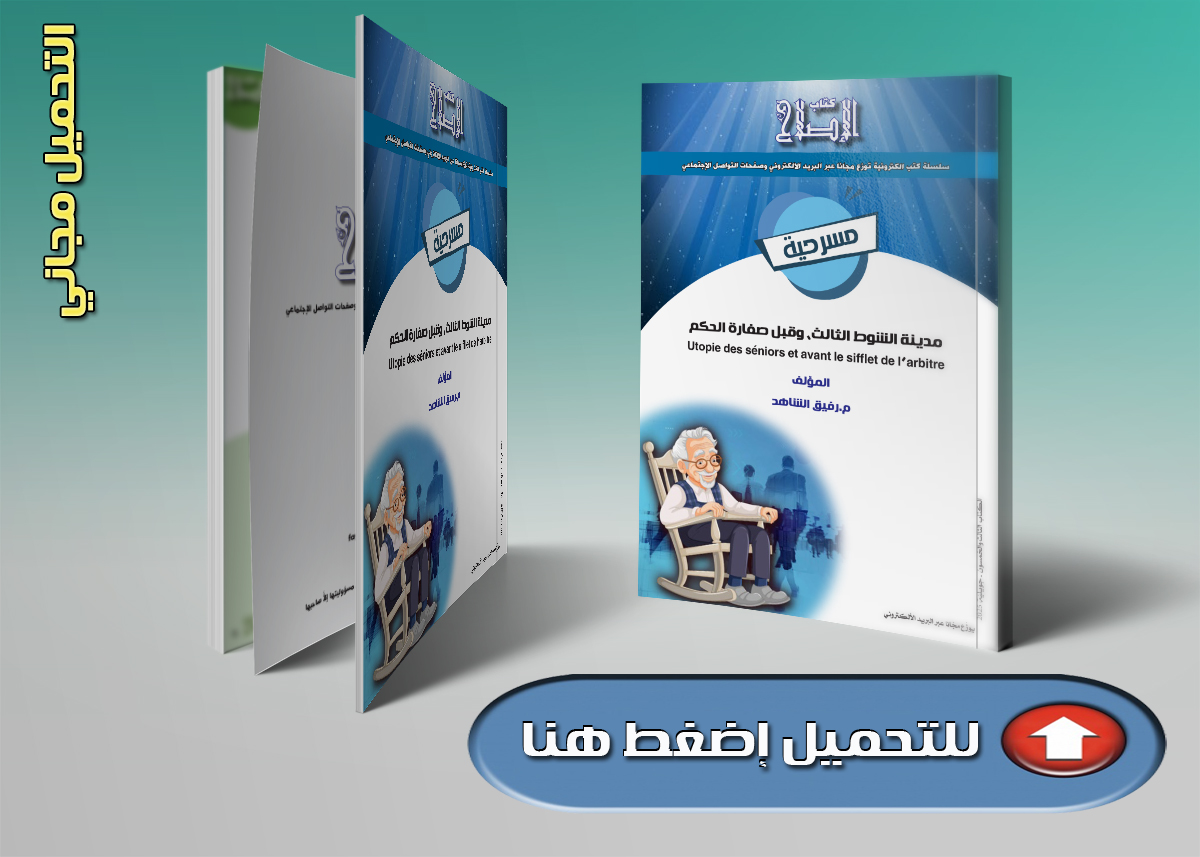-
لا يُمكن قراءة المشروع الصّهيونيّ في فلسطين بمعزلٍ عن عموده الفقريّ: الاستيطان؛ فهو ليس مجرّد إجراءٍ سكنيّ أو توسّعٍ عمرانيّ، بل هو الأداة التّنفيذية للأيديولوجيا الصّهيونية التي رفعت شعار «أرضٌ بلا شعبٍ لشعبٍ بلا أرض». ورغم أنّ هذا المشروع اتّسم لعقودٍ بسياسة «الزّحف الصّامت»، إلّا أنّ الضّفّة الغربيّة شهدت بعد السّابع من أكتوبر تحوّلاً جذريّاً نحو «التّسريع العنيف» لبنية الاستعمار الاستيطانيّ، حيث انتقلت الممارسات الصّهيونيّة إلى تطبيق سياسات الضمّ الفعليّ والقسريّ تحت غطاء الحرب على غزّة. في هذه المرحلة، تماهى عنف الدّولة البيروقراطيّ مع عنف الميليشيات الاستيطانيّة، لينتقل الاحتلال من «إدارة الصّراع» إلى محاولة «حسمه» عبر التّطهير المكانيّ المباشر، مُستغِلّاً ضباب الحرب لفرض واقعٍ ديموغرافيّ وقانونيّ جديد.
يهدف هذا المقال إلى تفكيك بنية هذا الاستيطان وفلسفته، طارحاً السّؤال المركزيّ: إلى أيّ مدى يُجسّد ما يجري نموذجَ «الاستعمار الاستيطانيّ» القائم على منطق المحو لا الاحتلال العسكريّ التّقليديّ؟ وكيف يؤثّر هذا التّصنيف في فهمنا لطبيعة الصّراع، وآليّات حلّه، ومآلاته؟
م.فيصل العش
-
الإنسان غاية الدّين، وليس وسيلة للدّين، ولا أداة للسّلطة أو المؤسّسة أو الجماعة. كلّ دين لا يتّخذ الإنسان غايته، ولا يجعل صون كرامته بوصلة له، ليس دينًا إنسانيًّا. جوهر إنسانيّة الدّين أن يحمي الكرامة، ويرفض كلّ أشكال التّمييز بين النّاس، على اختلاف أعراقهم، وأديانهم، وثقافاتهم، وأوطانهم. لا يتحقّق دين الرّحمة والمحبّة والكرامة والمساواة والحرّية، من دون مناهضة احتقار الإنسان، ورفض إذلاله، وانتهاك كرامته، وسلب حرّيته، بسبب اختلاف العقيدة، أو اللّون، أو الطّبقة، أو الجنس. الكرامة لا تتحقّق من دون مساواة، والعدالة لا تقوم بلا كرامة. خلق اللّه النّاس متساوين في إنسانيّتهم، لا تفاضل بينهم في أصل الخلق، ولا يكتمل المعنى الرّوحي الأخلاقي للدّين ما لم يحمل هذا الوعي، ويترجمه في الواقع. تختبر أخلاقيّة أيّ ديانة بما ترسّخه من قيم الكرامة والحرّية والمساواة والعدالة والحقوق، وبما تسهم فيه من تحرير الإنسان من الاستعباد بكلّ صوره، وبقدرتها على حمايته من الإحتقار والإذلال والنّبذ والاستعباد.
أ.د.عبدالجبار الرفاعي
-
يُعدّ كتاب الدّكتور مصدق جليدي «البنائيّة الاستخلافيّة: بديل تربوي حضاري» دراسة رائدة في الفكر التّربوي البنائي الحضاري، حيث يسعى المؤلّف إلى تقديم رؤية تربويّة جديدة ترتكز على مفهوم البنائيّة الاستخلافيّة كأساس لبناء شخصيّة متوازنة ومجتمع متطوّر مساهم بفاعليّة في الحضارة الإنسانيّة، من خلال التّأليف بين مقومات الأصالة وثوابتها ومقتضيات الحداثة ومتطلباتها من خلال مفهوم الأصالة الحديثة. وقد سعينا من خلال هذا المقال إلى تقديم قراءة تحليليّة للكتاب، مبرزين في الجزء الأول منه (هذا العدد) الإشكاليّة التي ركّز عليها الكاتب في بحثه، ثمّ عرض أسس الفكر التربوي الأصيل ومقوّماته ومن ثمّة التطرّق إلى خصائصه ومميّزاته. ونخصّص الجزء الثاني (العدد القادم) إن شاء الله لاستعراض جوانب الالتقاء والتماثل بين الفكر التربوي الأصيل والفكر الإنساني الحديث من جهة و جوانب التّمايز بينهما من جهة أخرى، ونختم المقال بعرض النّظريّة البنائيّة الاستخلافيّة كبديل تربوي حضاري جديد كما يقترحها الأستاذ مصدق الجليدي
خليفة بن مسعود
-
فرضت التمكّنات التّقنية التي بات الإنسان يسكن بين آلاتها، طُرقًا في التَّدبير لم تكن معهودةً(1)، والذي يهمّنا في هذا المقام، هو: التَّدبيرات التَّربوية، وما يُلَازمها من مفاهيم وتقنيات وغايات، أي مفاهيم الكلّيات التَّعليمية وكيفيّات إنجاز الفعل التَّعليمي والغايات التي يتقصَّدُها القائم على هذه المحدّدات.
وقبل الاسترسال في الحديث عن بؤرة الموضوع، فإنّه يجب علينا، بِدءًا استجلاء الفارق بين التَّربية والتّعليم؛ فالتَّربية هي اهتمام بالجوانب الحيويّة وتنمية لقوى الجسم؛ في ما يُعرف بتلبية الدَّوافع الحيويّة مثل دافع التغذِّي والرّعاية؛ بينما التَّعليم هو تنمية للقوى الرّوحيّة والعقليّة والنَّفسيّة في الذّات؛ إنَّه بناء في عمق الوظائف العليا التي هي مركز الدّائرة ومحور المحيط. لذلك، نجد أنّ كلمة التَّربية، بما هي اهتمام بالجوانب الحيويّة، تتقاطع في وظيفتها مع غير الإنسان: فهناك تربية النَّحل وتربية الأسماك وتربية الأبقار وغيرها، بينما التَّعليم إنّما هو الخاصِّية الجوهريّة الإنسانيّة المُتفرِّدة، التي تتسانَد تكامُليًّا في أفعالها مع أدوار نوعيّة أساسيّة؛ يمكن إظهارها في: تقوية الوِجدان الرّوحي، والتَّوجيه نحو القيم وتنمية الذَّائفة الجماليّة الرَّفيعة وتعليم الوجود الكريم معًا، ونظرًا لهذا المُحدّد الجوهري في الذّات؛ لا عجب أن يقال عن الإنسان إنّه مخلوق قارئ!.
أ.د. عبدالرزاق بلقروز
-
لا يختلف المختصّون في أنّ النّظام الماليّ لا يكتمل بنيانه إلاّ بتضافر أنماط تمويلٍ وهياكلَ وأسواقٍ ومؤسّسات. وقد تعرّضنا، في مقالات سابقة، لتلك الأنماط، كالتّمويل الجماعيّ والزّكاة والوقف، ولتلك الهياكل، كالجهاز المصرفيّ وصناديق الاستثمار وسوق المال(1). ونشرع في هذا المقال في بحث مؤسّسات التّمويل الصّغير، بصفتها أولى لبنات ذلك النّظام، قبل أن نختم البحث بدراسة مُؤسّستي التّأمين والإيجار الماليّ؛ ويأتي هذا الجهد مساهمةً منّا في بلورة دراساتٍ وبدائلَ ضمن نشاط «منتدى الفارابي للدّراسات والبدائل»، واللهُ المَقصِدُ وهو وليّ التّوفيق.
نجم الدّين غربال
-
يأتي هذا المقال ردّاً على ما ورد في مقال «ماذا لو سلّمت المقاومة في غزّة سلاحها؟» للمهندس فيصل العش المنشور في العدد 220 من مجلة الإصلاح. وإذ يطرح المقال المذكور فرضيّة نزع السّلاح كمدخل لإنهاء الحرب، فإنّ هذا الردّ يسعى إلى إعادة وضع السؤال في سياق إضافي : سياق المشروع العقدي الصّهيوني الذي يتجاوز غزّة إلى الوجود الفلسطيني برمّته. فالحديث حول السّلاح ليس تقنياً ولا عسكرياً فقط، بل مسألة وجود وبقاء. يذهب المقال المذكور إلى أنّ إصرار العدوّ على نزع سلاح المقاومة يعود إلى دوره في تسريع الهجرة العكسيّة من “دولة الكيان”، وفي تسهيل التّغلغل الاستيطاني، وفي تقويض بنية المقاومة السّياسية والعسكريّة والاجتماعيّة. ثمّ يعرض المقال أمثلة تاريخيّة لنتائج تسليم السّلاح في تجارب مشابهة. غير أنّ النّقاش يظلّ ناقصاً ما لم تُقرأ الحرب الدّائرة منذ السّابع من أكتوبر في سياقاتها الأعمق: السّياق العقدي الصهيوني، والسّياق السّياسي التّحويلي داخل الكيان، و السّياق الإقليمي الذي يعاد تشكيله تحت النّار.
م. خالد بن عمر
-
حاز مبحث تطوّر العلوم في الحضارة العربيّة الإسلاميّة اهتمامًا ملحوظًا في الدّراسات الغربيّة، وضمن هذا السّياق يأتي كتاب الباحث الإيطاليّ غولييلمو رينزيفيللو «الإسلام وتطوّر المعارف العلميّة والتّقنيّة»(1)، بوصفه محاولةً لرصد تلك المنجزات وتتبّع مساراتها وتقفّي محفّزاتها. يُفرد المؤلّف منذ مطلع كتابه فصلاً للحديث عن بدايات التّرجمة، بوصفها مفتاح عصر التّحوّل العلميّ العربيّ، حيث مثّل القرنان التّاسع والعاشر الميلاديّان عمق التّطوّر والاستيعاب للثّقافات المغايرة. هذا وقد أطلّ مع تلك الحقبة ملمح ثقافة تعدّديّة، استُهلّت بالبحث عن علوم الأوائل، عبر الحرص على اكتشاف تراثات الإغريق والفرس والهنود، وتعريب مختارات منها وتوظيفها في الفروع المعرفيّة النّاشئة.
د.عزالدين عناية
-
إنّ تطرّقنا بالدّراسة لحادثة الإفك يدخل في باب إعادة فهم ما يُشكّل الوعي الحالي، إنْ بصورة كلّية أو جزئيّة. ومن هذا المنطلق يتأكّد الحفر في صفحات عديدة من الموروث لإعادة بنائه عبر الفهم والنّقد والمقارنة والتّدقيق انطلاقا من عرض الرّواية على الرّواية، وإظهار ما تعمّدت الأعراف الثّقافيّة إخفاءه رغم ورود ما يدلّ عليه في المدوّنات والموسوعات. وليس أمام البحث العلمي إلاّ النّبش في الوثائق وتدبّر النّصوص من أجل إنتاج معارف جديدة وأفهام مغايرة لما صوّر على أنّه نهائي. وإذا أثبتت التّواريخ بطلان رواية أو زيف حكاية، فإنّ واجب الباحث لا يزيد عن التّنبيه والتّوضيح.
تطرقنا في الحلقتين الأوليين من هذه السلسلة إلى قصّة حادثة الإفك في التراث، ثمّ خصّصنا ثلاث حلقات متتالية للحديث عن المستشرقين وما توّصلوا إليه من نتائج من وحي هذه القصّة.ثمّ خصصنا الحلقة السادسة للنبش في سند الرواية التراثية ومتنها، لتتهاوى أمام الحجّة والبرهان، ثمّ قمنا في الحلقة السابعة بتقديم عرض نراه كاشفا لحقيقة ما تضمّنته سورة النّور من حقائق وأفكار .وخلصنا إلى ضرورة مزيد التّمحيص في المرويّات نظرا لتأثرها بالسّياق الاجتماعي والسّياسي والمذهبي في زمانها، وبناء على ذلك تحدثنا في الحلقة الثامنة عن حادثة التّحكيم بوصفها منعرجا خطيرا في حياة المسلمين، كان له كبير الأثر في توجيه الثّقافة توجيها مخصوصا حيث تترسّخ غلبة السّياسي على الدّيني. وبيّنا في الحلقة السابقة كيف أدّى ذلك إلى هيمنة النّزعة القهريّة في فهم المُصحف فهما معيّنا وتوجيه معانيه توجيها قيصريّا يتماهى مع الموقف السّياسي السّائد القائم على القهر. ونواصل في هذه الحلقة تبيان كيف تلحق السّلطة السّياسيّة التشويه بالجوانب الدّينيّة كلّما بسطت نفوذها عليها. وكلّما امتزج السّياسي بالدّيني لحقهما الضّيم. فيقدّس غير المقدّس. ويصبح الوعي الدّيني حاملا لمعاني الضّعف والعجز.
د.ناجي حجلاوي
-
لا تُعدّ اللّغة العربيّة مجرّد وسيلة للتّواصل فحسب، بل هي وعاءٌ للهُوِيّة وضمانةٌ لمستقبل الأمّة؛ لذا وجب حمايتها وإحياؤها عبر سياسات واستراتيجيّات فعّالة. ضمن هذا السياق، تأتي هذه الدراسة الموزّعة على جزأين: نستعرض في الأول اللّغة العربيّة من منظور حضاريّ وتاريخيّ ومعرفيّ، مناقشين مكانتها بين لغات العالم ودورها في بناء الهُوِيّة والثّقافة والعلوم، ثمّ نتناول التّحدّيات الّتي تواجهها في العصر الحديث، مثل الإهمال التّعليميّ والقصور التّكنولوجيّ وتأثيرات العولمة. على أن نخصّص الجزء الثاني (في العدد القادم إن شاء الله) لاقتراح إستراتيجيّات عمليّة للحفاظ على لغتنا وتفعيل استخدامها في مختلف المجالات العلميّة والإداريّة والإعلاميّة.
أ.د عبد الفتاح داودي
-
لا مناص من التّذكير بمعنى فقه الميزان حتّى لا نغرق في التّطبيقات والأمثلة. فقه الميزان هو الحلقة الوسطى الواصلة بين الواجب والممكن. وهو القنطرة التي تؤمّن تنزيلا حسنا مناسبا للحكم الشرعيّ (بل والعقليّ والعاديّ نفسه) على الأرض والحياة. الحاجة إليه ماسّة بسبب الطّبيعة التّركيبيّة للدّين من جهة وللعقل من جهة أخرى وللحياة من جهة ثالثة. الطّبيعة التّركيبيّة معناها تعدّد الأبعاد وإنتفاء البعد الواحد. المقصد الأسمى من فقه الميزان هو تحقيق العدل وترسيخ القسط في كلّ معاملة قدر الإمكان.
الهادي بريك
-
يُعدّ التّغيير أحد الثّوابت الكونيّة الّتي لا يمكن للإنسان الإفلات منها. فالوجود في حدّ ذاته ديناميكيّ، قائم على التّحوّل المستمرّ سواء في الطّبيعة أو في حياة المجتمعات والأفراد. من ظواهر المناخ إلى تحوّلات الفكر، ومن نشوء الحضارات إلى اندثارها، يبقى التّغيير القوّة المحرّكة الّتي تعيد تشكيل الواقع باستمرار. في جوهره، يُجسّد قانون التّغيير مبدأً حتميّاً: لا شيء يظلّ على حاله، وكلّ فعل إنسانيّ لا بدّ أن يتفاعل مع السّياق المتغيّر.
محمد أمين هبيري
-
تبحث هذه الدّراسة التي ننشرها على ثلاث حلقات رسم خارطة انتشار الإسلاميين في تونس وتفكيك مقالاتهم والبحث في المسكوت عنه في مواقفهم وأفعالهم وأقوالهم في فترة العشر سنوات التي تلت أحداث ثورة 2010-2011. خصصنا الحلقة الأولى لتقديم قراءة موجزة في المفاهيم والمصطلحات ثمّ استعراض الخطاب الإسلامي في المؤسّسات الرّسمية التّونسيّة وتحليله. وفي الحلقة السّابقة انطلقنا في تحليل خطاب الجماعات الدّينية والأحزاب السّياسيّة الإسلاميّة (الحركة الإسلاميّة الإحيائيّة (النهضة)، والتّيار الإسلامي السّلفي، وحزب التّحرير) ، وسنقوم في هذه الحلقة بتحليل الخطاب الإسلامي الحداثي وخطاب اليسار التّونسي في المسألة الإسلاميّة. أمّا الحلقة القادمة والأخيرة فسنخصّصها لمبحث خاص بالخطاب الإسلامي في مراكز البحث والدّراسات (مركز الإسلام والدّيمقراطية، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث)، مع خاتمة نلخّص فيها النتائج.
د. محمد شكري المرزوقي
-
تمثّل الأزمات محكّا أساسيّا لاختبار طبيعة المجتمعات ومدى تماسكها أو حدود تفكّكها، ويمثّل الوباء أهمّ هذه الأزمات قسوة وصلابة. سوف نسعى من خلال هذه القراءة إلى تبيّن علاقة الطّاعون الجارف خلال القرن 14 بسعي الفقهاء إلى إنتاج ممارسات أخلاقيّة إمّا لترميم ما فقد منها زمن الأزمة، أو للتوقّي ممّا يمكن أن يحصل، وخاصّة لحماية الكليّات الشّرعيّة الخمس (العقل، العرض، المال، النسل، الدّين) التي يمكن أن تفقد أو تضيع أو تُنتهك زمن الأزمة حيث يضعف الدّين وتتخلخل مكانة السّلطة المركزيّة المحكّمة بين النّاس. وقد أخذنا مجال افريقيّة كفضاء حضاريّ مهمّ للدّراسة.
د. محمد البشير رازقي
-
لَم يشغَلِ العالَمَ العربيَّ والإسلاميَّ عبرَ التاريخِ أمرٌ كما شغَلَتْه الحركاتُ الباطنيةُ بما أثارته من تساؤلاتٍ، وما خلّفته من تأثيراتٍ عَقَدِيّة وفكريّة. وهذه محاولةٌ لاستجلاءِ الحقيقةِ العلميّةِ المتعلّقة بهذه الطّوائف، من خلال تتبّع ما كُتِبَ عنها من معطياتٍ تاريخيّةٍ وبياناتٍ موثوقة. وقد سُمّيت الباطنيّة بهذا الاسم – كما يذكر الغزالي – «لِدَعواهم أنَّ لظَواهِرِ القرآنِ والأخبارِ بَواطنَ تجري في الظواهرِ مجرى اللّبِّ من القِشرة، وأنها بصورها تُوهِمُ عند الجهّالِ الأغبياءِ صُوَرًا جَليّة» .
د. سهام قادري
-
يُعرِّف أنصار «نظريّة التقمُّص» النَّفسَ بوصفها كيانًا مستقلًّا لا يفنى بموت الجسد، بل ينتقل إلى جسد بشريّ جديد ليبدأ حياة أخرى، ضمن سلسلة من الحيوات المتعاقبة تهدف – بحسب زعمهم – إلى التَّعلُّم والتَّطهير وتحقيق الكمال. وهذا التَّصوُّر، وإن حاول أصحابه التَّمييز بين «النَّفس» و«الرُّوح»، لا يخرج في جوهره عن عقيدة تناسخ الأرواح المعروفة في الدِّيانات والفلسفات الشَّرقيَّة، كالهندوسيَّة والبوذيَّة. وفي المقابل، يرفض الإسلام هذا التَّصوُّر رفضًا قاطعًا، ويؤسِّس بديلًا عقديًّا واضحًا يقوم على الحياة الواحدة، ثمّ البرزخ، فالقيامة، حيث يُبعث الإنسان بجسده ونفسه للحساب والجزاء. ومن هنا يبرز السُّؤال المركزيّ: هل التقمُّص تفسيرٌ حقيقيٌّ للعدل الإلهيّ، أم أنّه محاولة عقليّة قاصرة تُفرغ العدل من حكمته وتحوِّله إلى قانون آليّ جامد؟
شكري سلطاني
-
ممّا لا شكّ فيه أنّ التّاريخ إمّا أن يكون شاهداً لك أو شاهداً عليك. ولعلّ مناسبة الحديث هي أنّ المولى جلّ وعلا قدّر لي أن أصل الرّحم مع العائلة والأحباب والأصدقاء، وأصلّي الجمعة في هذه المنطقة الّتي تحمل تاريخاً مشهوداً عن الرّموز التّاريخيّة المغربيّة الّتي كان لها حضور في التّاريخ.
الخامس غفير
-
بعد أن تطرّقنا إلى الكبائر التي ورد ذكرها في السّور المدنيّة بصيغة «التّحريم»: أكل الميتة والدّم ولحم الخنزير، وما أهلّ به لغير اللّه، وصيد البرّ (للمحرم)، وأكل الرّبا، وزواج المحارم(1). ثمّ أتبعناها بالكبائر التي وردت في السّور المدنيّة بصيغة «لا تقربوا»: حدود اللّه، والصّلاة في حالة سكر أو جنابة، والنّساء في المحيض، والمشركين للمسجد الحرام(2). ثمّ التي وردت بصيغة «اجتنبوا»: الأَوْثَان، وعبادة الطّاغوت(3)، وكَثِيرًا مِنَ الظَّنّ، والْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ (4)، ثمّ التي تنتج عن عدم الاستجابة إلى ما ورد بصيغة الأمر «إنّ الله يأمر» : صلة الرّحم(5) وعدّة الطّلاق وإتيان المرأة من قبلها(6)0 وبعد أن تطرقنا في الحلقة السابقة إلى البغي (الاختلاف في الدّين) (7)، سنتحدث في هذه الحلقة عن تولّي المشرك أوالكافر / النّجوى بالإثم والعدوان بوصفهما من الكبائر التي وردت في القرآن الكريم بصيغة «النّهي».
م.لسعد سليم
-
تنصّ القاعدة المعروفة على أنّ أيّ سطح مغلق (بدون حدود أي ليس له حواف أو نهايات) في بعدين ومتّصل بسيط (بدون ثقوب) يكون مكافئًا توبولوجيًا للكرة. بمعنى آخر، أيّ حلقة مغلقة مرسومة على سطح كروي يمكن تقليصها إلى نقطة ( خاصّية تسمّى «التقليصيّة») أو فإنّ السّطح نفسه هو كرة. قام «هنري بوانكاريه» بتعميم هذه الفكرة على الكون الثّلاثي الأبعاد (أسطح ثلاثيّة الأبعاد مغلقة في فضاء رباعي الأبعاد). صاغ حدسيته الشّهيرة: «أيّ متعدّد الطّيّات مغلق ومتّصل بسيط ثلاثي الأبعاد هو مكافئ توبولوجيًّا للكرّة ثلاثيّة الأبعاد». بكلمات أبسط: إذا كان الكون الثّلاثي الأبعاد المغلق لا يحتوي على أيّ «ثقوب» توبولوجيّة وكلّ حلقة بداخله يمكن تقليصها إلى نقطة، فلا بدّ أنّه كرة.
أ.د.فوزي أحمد عبد السلام
-
في قريةٍ نائيةٍ بشمال المغرب، تقع في سفوح تلالٍ وهضاب، يفصلها غربًا عن القرى المجاورة وادي «ورغة»، وشعابٌ من جهتي الجنوب والشّرق، يشتغل أهلها بالفلاحة والرّعي، وبها حرفٌ تقليديّة يحتاج إليها الأهالي في مواسم ومناسباتٍ معيّنة، كالنّجارة والحدادة والبناء.. يتوسّطها مسجدٌ قديم، يتوفّر على جميع المرافق الضّروريّة، به إمامٌ راتبٌ شارطته جماعة القرية وفق الأعراف المعمول بها في القبيلة، من طعامٍ يوميٍّ وحبوبٍ تُجمع في نهاية العام، ومعاملاتٍ موسميّة تقدّم إليه في نهاية الخريف وعصر الزّيتون. مقابل ذلك، يقوم الإمام بمهامّ الأذان والصّلاة والجمعة والعيدين وتحفيظ القرآن للصّغار، والقيام بتجهيز الميّت والصّلاة عليه، والإفتاء عند الحاجة، وكتابة التّمائم لذوي الحاجات والأغراض.
محمد المرنيسي
-
ظهرتْ الشّيوعيّة في القرن التّاسع عشر، وانتشرت في العالم؛ في أوروبا الشّرقيّة وروسيا والصّين والشّرق الأوسط والهند الصّينيّة في القرن العشرين، وفي عالمنا العربي كثيرا ما جرى الخلط بينها وبين الاشتراكيّة لموقف الشّيوعيّة المرتبك من الدّين !..
عبدالقادر رالة
-
الدكتور عبد الإله بلقزيز هو أحد أبرز المفكرين والفلاسفة المغاربة المعاصرين، ويُعدّ صوتاً مركزيّاً في دراسات الفكر السّياسي العربي والإسلامي. من مواليد عام 1959. تحصّل على دكتوراة الفلسفة من جامعة محمد الخامس بالرّباط. وهو أستاذ الفلسفة في جامعة الحسن الثّاني في الدّار البيضاء. كان سابقاً الأمين العامّ للمنتدى المغربيّ العربيّ في الرّباط، ومستشارا ومديرا للدّراسات في «مركز دراسات الوحدة العربيّة» في بيروت. نال جائزة المغرب للكتاب في العامَين 2009 و2014، وجائزة السّلطان قابوس للثّقافة والفكر والفنّ عن مجموع أعماله الفكريّة في العام 2013. صدر له ما يزيد عن ستّين كتاباً في الفلسفة، والإسلاميّات، والفكر العربيّ، والفكر السياسيّ، فضلا عن مئات المقالات والدّراسات.
التحرير الإصلاح
-
سَنَظَلُّ نَتَنَفَّسُ،
لِنُعْلِنَ بِأَنَّ الرُّوْحَ فِي أَجْسَادِنَــا.
سَتَظَلُّ أَمَانِيْنَا الْمُجَنَّحَةُ مَحْفُوْظَةً فِيْ دَفَاتِرَنَا.
سَيَنْجَلِي الظَّلَامُ حَتْماً فِيْ مَوْعِدهِ .
وَتَرَى عُيُوْنُ أَجْيَالِنَا الْآتِيَّةُ مَا كَانَ يُــؤَرِّقُنَا.
د. محمّد فوضيل
-
أتعبتُها حُروفي
تَنثال عليّ لتَحملَ عنّـي
فيضيق مجالُها وينحسرْ
عَفوًا أحرفي
ما أضيق أمْداء عِلْمِكِ
بِتهويمات عقلي وكمائنِ صدريَ العَثِرْ
الشاذلي دمق